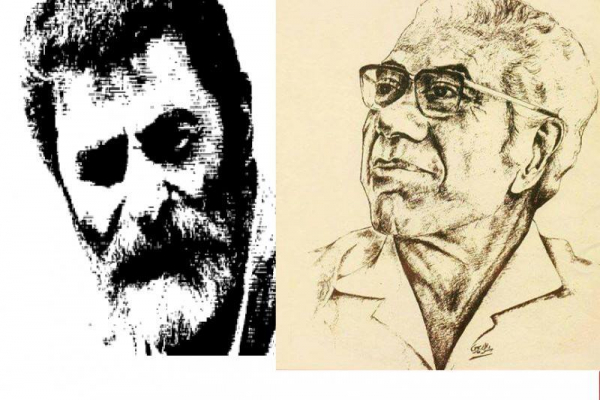في ذكرى اغتيال أحد أساتذتي: حسين مروة
1- لا للمدح أكتب أو للإطراء، بل لحاجة بي أن اقول كلمة شكر لك ومحبة، يا أبا نزار.
لعلك تذكر، أو لا تذكر، يوماً من أوساط الخمسينيات حين طلبت منك، بحياء وتردد، أن تقرأ لي أول نص كتبتُ. كان شيئاً يشبه القصة أو الاعتراف، نقلتُ فيه إلى اللغة حدثًا ولّد في نفسي مزيجاً ساذجاً من مشاعر الغضب والتمرد. كنت أبحث عن عمل، فنصحني أحد الأقرباء بأن أطلب من ثري كبير من الطائفة الشيعية أن يضع توقيعه الكامل على بطاقة بإسمه يدعم فيها طلبي وظيفة في أحد المصارف التي تحتضن أمواله. ذهبت إليه، خطوتين إلى الأمام وخطوة إلى الوراء، ووقفت عند بابه انتظر ساعة أو ساعتين قبل أن يسمح لي بالدخول. وانصرفت مزوّداً ببطاقة اسمه وتوقيعه. رفض المصرف طلبي. كنت عديم الموهبة في جمع الأرقام، وضعيفاً في اللغة الأجنبية. ثأرت للنفس بالكتابة، أو هكذا ظننتُ. قلتَ لي: ثابرْ. ثابرتُ على التمرد والكتابة. تلك كانت نصيحتك.
2- لستُ إلاّ واحداً من آخرين. كنا للوعي نولد شيئاً فشيئاً في صفحات "الثقافة الوطنية" و"الأخبار". نكبر بسرعة في المظاهرات، وتتكاثر علينا الأسئلة. بصبرٍ كنتَ تجيب، وبثقة تدفعنا إلى القراءة. كأنك تنتظر. وكأن دربك دربنا الآتي. إنه حدس المناضل، إذ يرى بالقلب، والقلب عين العقل عنده.
لم نكن بعد شيوعيين. حذّرونا في المدارس، والمجالس والنوادي. هددونا في الشوارع. قالوا: الشيوعيون ضد القومية والعروبة والوطن. ضد الوحدة والتراث، وضد الإسلام أيضاً. كان صعباً أن نكون شيوعيين، وأصعب ألاّ نكون. وألّح عليّ السؤال كثيراً: ما الذي يجعل من المثقف مناضلاً؟ ومن الكاتب كادحاً؟ كنا نرى إليك وإلى غيرك ممن كنا نقرأ لهم ونستمع إليهم يتحدثون عن الأدب والفكر والنقد والسياسة، ونتساءل: ما الذي يجعل مثل هذا النوع من المثقفين يرضى بمثل هذا النوع من الحياة القاسية حتى التقشف؟ ربما كان في السؤال كثير من السذاجة. لكنه كان مطروحاً بجدية كبرى. وما كان الجواب جاهزاً. وما أتى دفعة واحدة. كان ينضج في التهاب الأحداث وتسارعها، ويزداد وضوحاً في نهوض الحركة الوطنية ضد الإمبريالية وضد الرجعية في مصر بعد تأميم القناة، وفي العراق بعد ثورة 1958، وفي لبنان بعد الانتفاضة الشعبية ضد شمعون. وكانت أيام الصيف من هذه السنة تمر بنا مليئة بنقاش فتيّ أينما كنا. كل الأماكن كانت صالحة للنقاش: الطرقات والمقاهي والسينما، وأمام بائع الجرائد في شارع المعرض بالقرب من التياترو الكبير، وفي شارع سوريا تحت القناطر حيث يمتد صف طويل من المكتبات. وفي بيتك المتواضع، يا أبا نزار، في شارع البربور، حيث كان ينعقد دوماً مجلس الثقافة الوطنية والفكر التقدمي. كنا نشرب الشاي، ونتعلم منك الفرح في النضال.
نحن جيل بكامله حملنا إلى الثقافة شيئاً من مجلسك.
3- أقرأ اليوم شيوخاً في الثلاثين أو ما دونها، وأعجب للحياة كيف تنضب في عروقهم، وتجفُّ كلماتهم ولمّا تكتمل بعد أو تينع. وأراهم ينكفئون بها إلى ما قبل، كأن بهم داء الموت، وفي العيون اصفرار وضباب. انتهى زمن الأمل فيهم وشحبت أيامهم، كأنهم في دار عجزة، ينتظرون انطفاءهم، وينظّرون اليأس والعدم.
كيف لا أقارن، وأنت تُقدم، في الستين من عمرك أو يتعداها بقليل، فتياً رشيقاً حتى التهور، على عمل موسوعي يتهيّب من الإقدام عليه غيرك؟ وتبدأ من جديد رحلتك إلى العلم والمعرفة. كنتَ قد بدأتها من قبل، لمّا تركت، في مطلع عمرك، قريتك "حداثا" في جبل عامل، أو قل في جبل التراث من لبنان، وذهبت إلى النجف الأشرف لتصير شيخاً أو مرجعاً في الدين وعلومه. لكنك تركت العمامة، وظل فيك التراث تحمله في درب آخر هو الذي قادك إلى حزبك، وإلى الفكر الذي به ستنظر في التراث، موضوع علمك. هكذا انطلقت في مسيرتك الفكرية من التراث، وعدت إليه، مزوَّداً بمنهج يمكنّك من تملّكه المعرفي، أو من محاولة هذا التملّك. وكنت رائداً في هذه المحاولة، وجزئياً أيضاً. وها هو مؤلفك الضخم الذي أنجزته في جزئين على أبواب طبعته الثالثة، يستثير النقد من كل صوب، سلباً أو إيجاباً، فيحتدم به النقاش من جديد حول قضايا التراث ومناهج دراسته.
لقد قرأتُ الكثير من هذا النقد ومن هذا النقاش، وما زال كتابك مركزاً لهما، فالمعركة مستمرة حوله، يدخل فيها العالِم وغير العالِم، الأخصائي وغير الأخصائي، وتكثر فيها الأفكار المتضاربة التي تجد فيها العميق والسطحي معاً. فأحياناً يتقدم البحث، وغالباً ما تحدث البلبلة. فكيف ننظر في كتابك، وكيف ننظر في نقده؟
4- أطرح هذا السؤال وأتردد في الإجابة عنه، ربما لأنني لست مؤهلاً لذلك، فثقافتي في ميدان التراث لا تعطيني حق هذا النظر الذي يتطلب ثقافة موسوعية كثقافتك. ومع هذا، سأسمح لنفسي بإبداء بعض الملاحظات على الكتاب وعلى نقد له أرى في نقضه ضرورة يفرضها النظر في التراث ومنهج النظر فيه. أبدأها بملاحظة حول عنوان الكتاب نفسه، لسببين: أولهما أن هذا العنوان "النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية" يكاد يختصر موضوع عملك، أو قل إن فيه تكثفاً مشروعاً لحركة فكرك في استكشاف التراث ومعرفته. أما السبب الثاني، فهو أن تياراً بأكمله من النقد انصب فيه النقد على موضوع عملك هذا، فكان رافضاً له من أساسه، ورافضاً لمنهج من النظر في الفلسفة العربية الإسلامية هو منهج النظر في النزعات المادية في هذه الفلسفة؛ بل كان رافضاً رفضاً مبدئياً أو قل قبْلياً، وجود هذه النزعات فيها، وإمكانية هذا الوجود بالذات. المشكلة التي يطرحها مثل هذا التيار من النقد، برفضه هذا، لا تنحصر في حدود الفلسفة العربية الإسلامية ولا تقتصر عليها، بل تتعداها لتنطرح على كل فلسفة، قديمة أو جديدة، وعلى كل فكرٍ أيضاً، مهما اختلف حقول تحركه المعرفية. إنها مشكلة الفكر الذي به ننظر في التراث أو في غيره، سواء أكان هذا التراث فلسفة أو غير ذلك، وسواء أكانت الفلسفة هذه إسلامية أو غير ذلك، قبل أن تكون مشكلة هذا التراث أو هذه الفلسفة. والطابع القبْلي لذاك الرفض أو نقيضه يوكّد صحة قولنا، ويؤكد ضرورة أن يبدأ النقاش حول التراث، قبل النظر فيه، بنقد الفكر الذي به ننظر في هذا التراث. فأي فكر يتضمنه ذلك التيار من النقد الرافض مبدأ وجود نزعات مادية في الفلسفة الإسلامية؟ وما هي منطلقات هذا الفكر، وما هو منهجه؟
5- ثمة مقولة شهيرة في الفكر الماركسي تؤكد أن بالإمكان النظر في تاريخ الفكر الفلسفي، من حيث هو تاريخ الصراع فيه بين تياريه العريضين: تيار المثالية وتيار المادية، وأن كل واحد من هذين التيارين قد يظهر في أشكال تختلف باختلاف الشروط التاريخية والمعرفية الخاصة بتجدد حركة الصراع بينهما. من فضائل هذه المقولة أنها تسمح بعقلنة الأحداث الفلسفية وتساعد على اكتشاف البنى التي تنتظم في حقل إيديولوجي محدد تاريخياً، هو حقل الصراع بينهما، في ارتباطه العضوي بحقول الصراعات الاجتماعية الأخرى. فكما للتاريخ عقلانيته، من حيث هو تاريخ الكل الاجتماعي الذي له أيضاً عقلانيته في انبنائه الداخلي وتماسكه في كل واحدٍ معقّد، كذلك للفكر بعامة، وللفكر الفلسفي بخاصة، عقلانيته، سواء في انبنائه الداخلي وتماسكه في وحدة التناقضات والصراعات بين تياراته، أم في حركته التاريخية التطورية في إطار البنية الواحدة، وفي حركة قفزاته البنيوية التي يُنتقَل فيها من بنية إلى أخرى بأشكال مختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر، شكل تتفكك فيه بنية سابقة فيما تتكون بنية أخرى غيرها، ومنها أيضاً غير هذا الشكل، بحسب اختلاف الشروط والحقول المعرفية.
نحن إذن أمام أحد أمرين: إما أن نقبل بوجود عقلانية تحكم حركة التاريخ والمجتمع والفكر، فتكون معرفة التاريخ والمجتمع والفكر حينئذٍ ممكنة؛ وإمّا أن نرفض وجود مثل هذه العقلانية، فنرفض، تالياً، بهذا الرفض نفسه، المعرفة وإمكانها. وأقصد بالمعرفة هنا المعرفة العلمية. وحين أقول بضرورة وجود تلك العقلانية، لا افترض، بالطبع، أنها واحدة في التاريخ والمجتمع والفكر، لا افترض أنها واحدة في كل حقل من حقول الفكر أو ميدان من ميادين المعرفة، بل أقبل باختلافها فيما أؤكد تمفصلها على العقلانيات الأخرى في وحدة الكل الاجتماعي المعقد. أفترض هذا كمنطلق ضروري للنظر، ثم أبحث في الأشكال التاريخية المميزة التي فيها مثل هذه العقلانية، وفيها تتمفصل على غيرها في وحدة هذا الكل الاجتماعي التاريخي الواحد، وتتغير أو لا تتغير في تمرحله.
6- لا أدخل في بحث نظري، بل أتابع ما بدأت فأقول إن تلك المقولة الماركسية يعرفها الكثيرون، ويعرفها أيضاً ذلك التيار من النقد الذي نحن الآن بصدد نقده. لكنه، أغلب الظن، يعرفها مشوَّهة، وهو الذي يشوِّهها، لأن الفكر لذي يستند اليه فكر ميتافيزيقي، يظهر بوضوح في فهم الصراع بين المثالية والمادية على الوجه التالي: إما أن يكون الفكر مثالياً بكامله، صافياً في مثاليته، وإما أن يكون مادياً بكامله، صافياً في ماديته، فلا يحتمل هذا وجود أي عنصر أو نزعة مثالية خفية فيه، ولا يحتمل ذاك، بالعكس، وجود أي عنصر أو نزعة مادية فيه. لا وجود، بتعبير آخر، في الفكر الواحد، لصراع بين نزعتين، بل الصراع هذا قائم، كان موجوداً، بين مجموعتين متماسكتين من الفلاسفة الأفراد، كل واحدة منهما تمثل إحدى النزعتين. فإذا نظرنا، بهذا الفكر، في الفلسفة العربية، وجدنا أن هذه الفلسفة إسلامية، وهي لأنها كذلك، لا بدّ من أن تكون خالية من أي ثنائية مادية. هكذا يتعطل الصراع في هذه الفلسفة بين النزعتين، ويظهر فيها مظهر الصراع بين شكلين أو أكثر من النزعة المثالية الواحدة - بين العقل والحدس، مثلاً، أو بين الفقه والتصوف -، ويظهر موضوع بحثك كأنه باطل.
وينفى وجود أي نزعة مادية في هذه الفلسفة الإسلامية التي هي، في شتى تياراتها، صافية في مثاليتها، تظهر النزعات المادية فيها كأنها نتيجة "إسقاط الرغبات الذاتية" للباحث المادي عليها، على حد قول أحد النقّاد. هكذا، بالاستناد إلى مثل هذا الفهم الخاطئ لمقولة الصراع بين المادية والمثالية، يأخذ عليك البعض "انتقائية" ترى بها إبن سينا، أو غيره، مفكراً مادياً في نظريته للوجود مثلاً، بينما هو مثالي بحت في بنية فكره، وصوفي إشراقي أيضاً. فكيف تجتمع المثالية والمادية في الفكر الواحد؟
هذا ما لا يقدر على فهمه فكر ميتافيزيقي، وهذا ما لا يفهمه سوى فكر ديالكتيكي يحكمه منطق التناقض. والتناقض هو في قلب الأشياء قبل أن يكون في منطق الفكر. بهذا المنطق نظرتَ في الفكر الفلسفي الإسلامي، وكانت نظرتك صائبة جريئة في منهجها. لئن رحتَ تستكشف النزعات المادية في هذا الفكر، على امتداد تطوره التاريخي، فليس لأنك رأيت فيه، قبْلياً، فكراً مادياً هو إسقاط منك عليه - كما يتهمك البعض - أو لأن بنيته الإسلامية أو المثالية قد غابت عنك، مع أنك بالعكس، وعلى نقيض ما يتهمك به البعض الآخر، حاولتَ بإلحاح أن تبرز ميزة هذا الفكر بأنه إسلامي، حتى في بعض مواقفه المادية أو الإلحادية - لأن المشكلة الأساسية التي تحدده، في تكونه وانبناء تياراته المتصارعة، هي مشكلة التوحيد التي بها يتميز من الفكر اليوناني، ومن كل فكر غيره تأثّر به. ولم يكن استكشافك تلك النزعات المادية فيه نتيجة تفكيك بنيته وانتقاء عناصر منها على حساب عناصر أخرى تساقطت منه، بل لأنك فهمت تلك المقولة الماركسية فهماً ديالكتيكياً هو الذي في ضوئه حاولت أن تنظر في التراث الفكري العربي، فرأيت فيه وفي حركته التاريخية صراعاً بين النزعتين: المثالية والمادية، ورأيت الصراع هذا يحتدم فيه بين تيارات متعددة وحول قضايا مختلفة.
قد لا يكون هذا جديداً كلياً. لكن، ربما كان الجديد في أنك رأيت الصراع هذا وتتبعته في الفكر الواحد من كل مفكر، في فكر الكندي، مثلاً، أو الفارابي أو إبن عربي أو إخوان الصفا. لكنك في الوقت نفسه، حاولت أن تبيّن كيف كانت الهيمنة، غالياً، للطابع المثالي في هذا الفكر.
ربما يظهر للقارئ، للوهلة الأولى، أن التأكيد هو على وجود نزعات مادية أكثر منه على وجود الصراع بين هذه النزعات التي تسميها أحياناً، بلغة هيجيلية، "جنينية"، وبين النزعات المثالية المهيمنة في الفكر الواحد، في إطار انتمائه إلى الفكر الإسلامي وتميزه به. وربما لم تعطِ أشكال هذا الصراع وأشكال هيمنة النزعة المثالية على النزعات المادية في بنية الفكر الواحد حقها من البحث والاستكشاف، أو كان حقها منهما قليلاً إذا ما قيس بالجهد المبذول في التنقيب عن النزعات المادية واستخراجها. أقول هذا، ولا أجزم فيه، فلعل قراءتي كانت سريعة أو غير وافية. لكن الواضح هو أن منهج البحث في هذا الصراع صحيح وضروري. فالقول عن فكر ما، كالفكر الإسلامي مثلاً، أو فكر واحد من ممثليه، إنه فكر مثالي أو ديني لا ينفي وجود نزعات مادية فيه، بل يعني أن النزعة المهيمنة فيه هي النزعة المثالية، وأن النزعات المادية، إن وُجِدت، فبشكل تخضع فيه لهذه الهيمنة، وتقوم بها في وحدة الفكر الواحد وتماسك بنيته التناقضية، أو الصراعية. كالقول عن فكر آخر أنه فكر مادي، فهو يعني أن ما قد يوجد فيه من عناصر مثالية تتنازعه أو تتجاذبه، إنما هي فيه خاضعة لهيمنة النزعة المادية التي بها تتماسك في وحدة بنيته. هذا يصح على الفكر الأفلاطوني المثالي مثلاً، كما يصح على فكر ماركس نفسه، لا سيما في بدايات تكوّنه. بهذا التناقض يتحرك الفكر وتدخل فيه حياة التاريخ، أو يدخل التاريخ وحركته المادية. وإلاّ، فإن التجوهر مصيره، أي الموت والجمود. ولا نفهم، حينئذٍ، من أين يأتي هذا الفكر، ولا نفهم كيف يتكون وينبني ويصير.