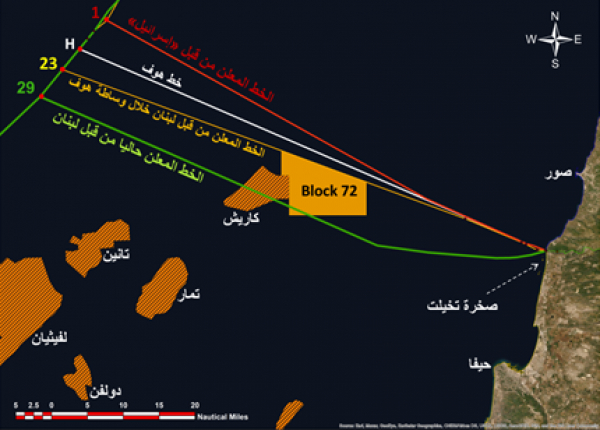الأزمة الاقتصادية في لبنان: نحو تغيير من أجل الأكثرية وليس القلة
أخيراً، ماريانا مازوكاتو، الاقتصادية في جامعة لندن تقول أن الرأسمالية تواجه عدة معضلات منها الركود والتقلبات في النمو، وازدياد عدم المساواة وركود الأجور، وأزمة التغير المناخي والخطر البيئي. نحن في لبنان منذ 1992 وحتى الآن فشلنا في جميع هذه النواحي وبنينا اقتصاداً ريعياً ضمرت فيه القطاعات الإنتاجية ونتج عنه الكثير من التشوّهات الني يعاني منها اللبنانيون بأكثريتهم وخصوصاً الشباب اللبناني والمتعلم منه الذي يواجه ثلاثة احتمالات إمّا البطالة أو البطالة المقنّعة أو الهجرة. ومن أوجه الفشل هذا: في تقرير التنافسية الصادر عام 2019 عن المنتدى الاقتصادي العالمي حلّ لبنان في المرتبة العاشرة بين 14 دولة عربية. ثانياً، أنّ الاقتصاد اللبناني تسيطر عليه القطاعات المتدنية الإنتاجية حيث تتركز الوظائف ويعمل حوالي 48 بالمائة من العاملين. ثالثاً، الاقتصاد اللبناني يعاني من معضلة عدم خلق الوظائف الكافية في سوق العمل. رابعاً، تتركز البطالة بين الشباب، وتبلغ حصة الأجور من الناتج المحلي حوالي 25 بالمائة بينما كانت 50 بالمائة قبل الحرب. كما يشهد لبنان ازدياداً كبيراً في عدم المساواة في الدخل والثروة حيث 1 بالمائة من السكان يملكون 45 بالمائة من الثروة وتبلغ ثروة بضعة من كبار الأثرياء حوالي 30 بالمائة من الناتج المحلي وهي أعلى نسبة في العالم. أخيراً، يشهد لبنان استمرار الفقر بحيث يقبع حوالي ثلث اللبنانيين تحت خط الفقر ولم تتغير هذه النسبة منذ التسعينيّات وحتى الآن.
هذا كله حصل قبل ظواهر الأزمة الحالية لكن اليوم بالإضافة إلى ذلك كله وصل الاقتصاد اللبناني إلى الأزمة النقدية والمالية التي ظاهرها الأساسي هو شحّ الدولار وسعر الصرف المزدوج.
ولكن كيف وصلنا إلى هنا؟
بدءاً من عام 1992 أي مع مجيء حكومة الحريري الأولى تغيّرت السياسات المالية والنقدية بشكل جذري واعتمدت على ثلاث: تثبيت سعر الصرف كمرساة لمحاربة التضخم، وإحداث الإصلاح الضريبي الذي خفّض الضرائب على الرأسمال والأجور أو ما عُرف بسياسة "الجنة الضريبية، والإنفاق الكبير على بناء الدولة وإعادة الإعمار وبدء آليات المحاصصة الطائفية. كان لهذه الأعمدة تأثيرات مالية من حيث ارتفاع عجز الخزينة وتراكم الدّين العام وارتفاع الفوائد. ولقد كان لتثبيت سعر العملة وتراكم الدَّيْن العام الناتج عن الجنة الضريبية والفوائد العالية والحاجة إلى التدفّق الدائم لرؤوس الأموال، التأثير الأساس في تحوّل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد ريعي، فبُنيت ما يمكن أن نسمّيه الترويكا الاقتصادية بين المصارف ومصرف لبنان والدولة اللبنانية. وبنيت بذلك حلقة خبيثة حيث تصدّر الدولة سندات خزينة بفوائد مرتفعة بمباركة المصرف المركزي تشتريها المصارف (بالإضافة إلى الرأسماليين الكبار وبعض المدخّرين) مما أدّى إلى ارتفاع رأس المال المصارف منذ 1992 بأكثر من 140 مرة. وأصبحت الدورة الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على تدفق رؤوس الأموال من الخارج، بالإضافة الى تغيّر في بنية الأسعار فارتفع سعر الصرف الحقيقي ما أدّى إلى تراجع التنافسية اللبنانية.
وهنا يجب التشديد على أنّ المعضلة الأساسية لم تكن فقط في ربط سعر الليرة اللبنانية بالدولار، على الرغم من السلبيات التي رافقته وإنّما أيضاً في استعمال الدولار الأميركي وكأنه "عملة محلية" في التبادل والإقراض وفي ميزانيات العملاء الاقتصاديين. هذا يفسّر "عطش" النموذج الاقتصادي للدولار كما تبيّن في باريس 2 و3 وسيدر والهندسات المالية، فالمصرف المركزي لا يمكنه طبع الدولار عند الحاجة كما تفعل البنوك المركزية في العالم فنحن تخلينا عن "السيادة النقدية"، ودخلنا هذا في خضم هذه الأزمة من "شحّ الدولار".
الطائفية والاقتصاد
بعد الحرب، أصبح نظام الطائف يقطر مالاً بعد أن تمّ تشريكه مع الرأسمال في 1992. ففي بدايات عهد الطائف كانت العلاقة بين أطراف النظام ملتبسة وكانت بحاجة إلى الرأسمال الذي يربط بين الطوائف والرأسمالية وهو الرابط الذي تفكّك خلال الحرب. لكن هذه المرة تغيّر الرأسمال أو مرّ بمرحلة "الانمساخ"، فبينما كان النظام القديم مبنياً على أسطورة التجارة والخدمات، قام النظام الجديد على المال السريع والسهل من الدّين والفوائد وريع العقار. فكانت مهمة الرأسمال تحديد العائد على بناء "الدولة" الطائفية عبر الدّين العام وتحوّل النظام الطائفي من نظام الهيمنة الى نظام المحاصصة الذي استعمل المالية العامة كوسيط بين البورجوازية وقوى التحاصص الطائفي. وهذا النظام الجديد جعل الفساد جزءاً من الحوكمة في النظام؛ فالتوزيع يتم على الأساس المذهبي من وزارات ووظائف كبرى وصغرى وحتى مايكروية وفي المجالس المركزية والمناطقية، والمؤسسات العامة والتلزيمات والخدمات العامة وصولاً إلى الفدرالية والاقطاعيات. هذا كله عمّق إعادة التوزيع الطائفي الذي استبدل إعادة التوزيع الطبقي. وهذا أغبط الرأسمال الريعي، وحتى غير الريعي، الذي تُركت الساحة الطبقية خالية له من أي منافس؛ فعندما تكون الانقسامات طائفية، ينتصر الرأسمال على العمل. وهذا النظام التحاصصي- الريعي كان أيضاً سبباً أساسياً في إنهاك الاقتصاد المنتج وعطّل النمو الاقتصادي وأبطأ نموّ الإنتاجية من جهة وضخّم الثروات الريعية والعمل غير المنتج من جهة أخرى.
إذن، اليوم ومع أنّ ظواهر الأزمة نقدية، إلّا أنّ أسباب الأزمة تكمن في فشل النمط الريعي من الرأسمالية اللبنانية وفشل النظام السياسي الطائفي في ما يمكن اعتباره أزمة مزدوجة. ومن أجل إنهاء هذه الأزمة المزدوجة، نحن بحاجة إلى تغيير سياسي واقتصادي جذري من أجل أن نلقي جانباً النموذج الاقتصادي القديم ومن أجل بناء اقتصاد ديناميكي عصري إنتاجي يخرج لبنان ليس فقط من ظواهر الأزمة الحالية بل من تراجع الاقتصاد اللبناني الذي يؤدّي إلى البطالة والهجرة وتراجع الترقي الاجتماعي وتراجع الطبقة العاملة وإنهاء الطبقة الوسطى. كما أنّ قيام الدولة العلمانية الديمقراطية لإنهاء دولة المحاصصة المذهبية هي أولوية على المستوى الاقتصادي لفكّ الارتباط بين الرأسمال الريعي والدولة وأولوية على المستوى السياسي والاجتماعي من أجل قيام دولة ديمقراطية اجتماعية تقدمية تضع لبنان على سكة التطوّر الذي يليق بلبنان القرن الواحد والعشرين. في هذا الإطار يأتي "لقاء التغيير" في 23 شباط/ فبراير في مسرح المدينة ليؤطّر القوى التي يمكن أن تكون رافعة هذا التغيير الذي سيستكمِل المَهمة التي ابتدأت في 17 تشرين الأول/أكتوبر نحو غد أفضل لأكثرية اللبنانيين وليس للقلة منهم.